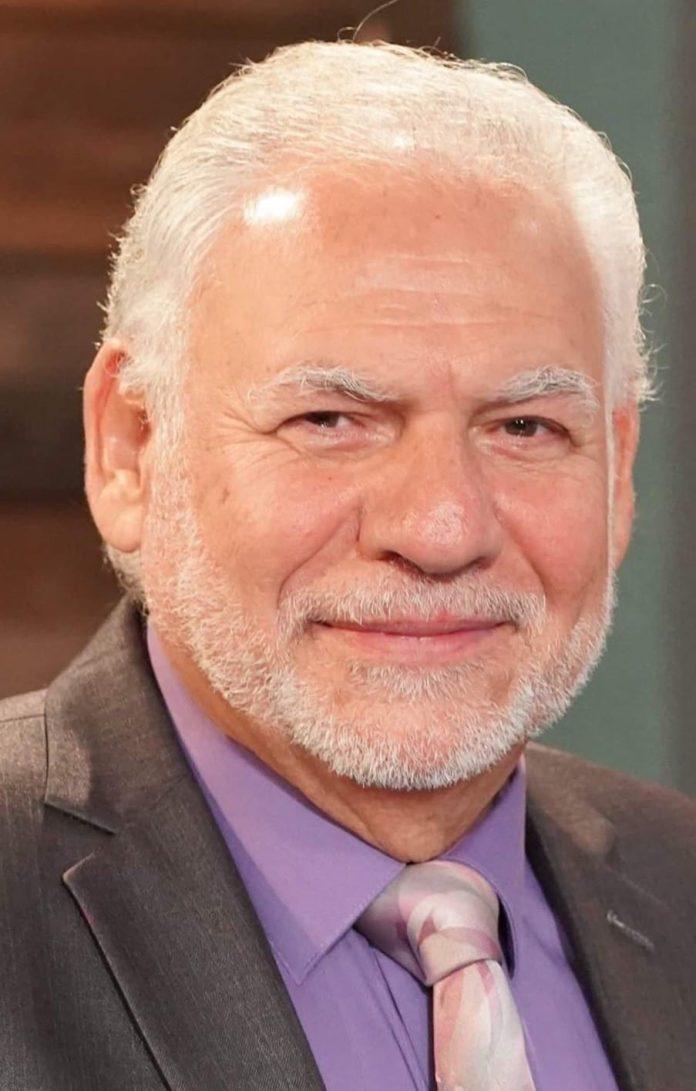لا شك أنه في كل مرة تُجرى فيها الانتخابات الأمريكية لاختيار رئيسها يخرج منها الأمريكان، بل والعالم كله، بدروس هامة ومحورية يستفيد منها مَنْ يرغب من الشعوب والرؤساء في رفع شأن بلادهم أمنيًا وعسكريًا واجتماعيًا بل وحتى روحيًا، حيث تُعد الانتخابات الأمريكية التي تُجرى كل أربع سنوات أكبر انتخابات تُجرى في العالم، فهي الأطول إعدادًا والأكثر دعايةً والأعظم إنفاقًا والأعمق تأثيرًا في العالم كله. فعلى سبيل المثال لا الحصر كانت إعادة انتخاب الرئيس السابق ترامب مرة ثانية ليتولى الرياسة لدورة أخرى في أمريكا بمثابة معجزة إلهية لم يكن يستطيع صنعها إلا القادر على كل شيء سبحانه، ففي خلال حياتي الطويلة على الأرض لم أر رئيسًا ما قد قاومته الغالبية العظمى من قادة وشعب الأحزاب المعارضة لحزبه، وهذا الكم الهائل من رؤساء الدول والممالك الأخرى، والكثيرون حتى من حزبه وشعبه، كما رأيتُ ما حدث مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب. أتذكر ليلة فرز أصوات الناخبين في الدورة الأولى التي فاز فيها على منافسته هيلاري كلينتون، يومها كنا أنا وزوجتي في زيارة لمصر ونتابع نتيجة الانتخابات على شاشة إحدى القنوات الأمريكية التلفزيونية، وقد رأينا بأم عيوننا كيف كان مذيعو الـ “سي إن إن” يسخرون منه ويتهكمون عليه ويتعجبون من مجرد فكرة أنه قام بترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية، لدرجة أننا اقتنعنا، زوجتي وأنا، أنه من المستحيل أن يفوز ترامب في تلك الانتخابات، الأمر الذي أصابنا بالإحباط واليأس وتوقفنا عن مشاهدة التليفزيون، حيث إن الساعة كانت تشير إلى الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة، فنمنا ونحن متأكدان أن ترامب خسر الانتخابات. لكن بعد أربع ساعات فقط، استيقظتُ لأشاهد آخر الأخبار فوجدته الفائز، يومها كتبتُ مقالي المعنون “دروس أساسية من نتائج الانتخابات الأمريكية”، والذي اقتبس منه الكثير في مقالي هذا، فما من شك أن العالم كله قد فوجئ في صباح السادس من نوفمبر 2024 بفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الثانية.
فوجئنا جميعًا بفوزه، كما فوجئ أيضًا بذلك الغالبية العظمى من مسئولي وأعضاء الحزب الجمهوري الأمريكي أنفسهم، والذين رفض البعض منهم، علنًا وبإصرار، التصويت لصالحه، أو أولئك الذين صوتوا لصالحه، والذين من بينهم أنا وزوجتي وأولادي، لا لحبهم له أو اقتناعهم الكامل به، بل لأنه الخيار الوحيد أمامنا كجمهوريين أمريكان. والحقيقة أننا جميعًا لم نكن نتوقع أن يفوز السيد ترامب بالرئاسة الأمريكية هذه المرة أيضًا، لأسباب عديدة سأذكر ما تيسر منها، إلى جانب الدروس المستفادة من كل واحدة من هذه الأسباب في عجالة في هذا المقال:
السبب الأول هو أن الشعب الأمريكي يتأثر في اختياره لرئيسه بتفاصيل حياته الدقيقة وشكله وشكل عائلته، وطريقة تربيته لأولاده، وما لديه من ثروة، وكيف حصل عليها، وإن كان قد سدد الضرائب المستحقة عليه بانتظام أم تهرب من دفع حتى ولو جزء بسيط منها، وطريقة معاملته وقبوله للسيدات، وعلاقاته النسائية، وموقفه من المهاجرين الجدد لأمريكا وخبرته في التعامل مع الدول الأخرى وعلاقاته الخارجية، بل وحتى التفاصيل الدقيقة لوجهه وشعره وطريقة حركات يديه وسرعة بديهته وطريقة كلامه ونطقه لألفاظه والعبارات التي يستخدمها في وصف مؤيديه ومعارضيه، وغيرها الكثير، فكل هذا يُحدِث تأثيرًا صغيرًا أو كبيرًا على نتائج الانتخابات ويحدد مدى قبول الشعب الأمريكي لرئيسه المنتخب. والحقيقة التي لا مفر من الاعتراف بها هي أنه لم تتجمع الكثير من هذه التفاصيل، بالصورة السلبية الواضحة، والتي من الممكن أن تؤثر سلبًا على مرشح أمريكي للرئاسة مثلما تجمعت في السيد ترامب، فأقل ما يقال عن ألفاظه ولغته إنها سوقية مستفزة، فهو لا ينتقي ألفاظه. فلم نسمع قبل اليوم أن مرشحًا للرئاسة الأمريكية يصف مَنْ ينافسه على الرئاسة من الرجال بأنه رجل فاسد أو منحل أو أعوج أو ملتوي أو نائم دائمًا ومختبئ في “الباسمنت” أي ما تحت الدور الأول في بيته الذي عادةً ما يجعله الأمريكان مكان لتخزين ما هم في غنى عنه، وأن قواه العقلية والبدنية ليست كفئًا للقيام بمهام الرئاسة الأمريكية كما كان ترامب يصف الرئيس الحالي چو بايدن ومن بعده مساعدته كامالا هاريس. فكم وكم لو كان الوصف يقال من مرشح رجل عن مرشحة امرأة! سواء أكانت منافسته هي كامالا أو مَنْ كانت مرشحة أمامه في فترة انتخابه الأولى وهي هيلاري كلينتون. لكن مما هو واضح فإن هذه اللغة السوقية وألفاظه غير المنمقة وإهانته للمرشحة أمامه علنًا أمام الجميع على شاشات التليفزيون كانت سببًا في كشف اعوجاج منافسته وكيف أنها ساعدته على كسب الانتخابات ليكون رئيسًا منتخبًا للولايات المتحدة الأمريكية، بالرغم من وقوف الرئيس الحالي بايدن وزوجته، والرئيس الأسبق أوباما وزوجته وبيل كلنتون وزوجته، مع كامالا، وخاصةً أوباما بكل إمكانياته البلاغية والخطابية، ومحاولة استخدامه لشعبيته في تدعيمها. لكن الفرق بين ما يحدث في الغالبية العظمى من بلادنا العربية وبين ما يحدث في بلاد الفرنجة هو أن الزعيم في بلاد الفرنجة “ما يقدرش يفضل في منصبه للأبد” ولا “يلهط على طول”، على حد تعبير عادل إمام في مسرحية “الزعيم”، لأنه في بلاد الفرنجة توجد أحزاب متضادة ومتنوعة حقيقية، لها كيان حقيقي وكلمة واضحة مدروسة ومسموعة حقيقية، ولها من الدراسات والتحليلات ما يكشف المستور، وعندها المليارات لفضح أي تلاعب في المعلومات والمراسلات والإيميلات والانتخابات، وأي تلاعب في العملية الانتخابية سيؤدي في النهاية إلى خسارة المتلاعب، كما حدث مع الديمقراطيين أكثر من مرة، وصندوق الانتخابات عندهم له قدسيته وهو مغلق إلكترونيًا بإحكام، وورق الانتخابات لا يتم توزيعه قبل العملية الانتخابية بأسابيع، والذين ينقلون أوراق الانتخاب من المطابع الأميرية الأمريكية إلى مواقع الاقتراع يكونون مراقبين بالكاميرات حتى وهم في دورات المياه الخاصة بهم، والنتائج تُعد وتحصى وتظهر في التو واللحظة بطريقة إلكترونية بمجرد أن يُدلي الناخب بصوته، وعملية إعادة فرز الأصوات -إن تطلب الأمر ذلك- لا تستغرق أكثر من ساعات قليلة، والقضاة ليسوا هم المسئولون عن صناديق الانتخابات، ومَنْ تسول له نفسه أن يتلاعب في أوراق الانتخابات يكون متأكدًا أنه لا بد أن يخترع طريقة جديدة يمكن بها أن يحقق مآربه دون أن يكتشفه أو يشك فيه أحد، فهو يعلم يقينًا أنه لا بد أن يُكْتَشف إن آجلًا أم عاجلًا، وعندها لا سماح ولا طرمخة ولا اتفاقات في الخفاء. ولا مكان للسكر والزيت والبطاطس في الانتخابات الأمريكية فجميعها متوافرة في المحلات وبأسعار أقل من أسعارها في أي مكان آخر في العالم، ولا حاجة للناخب أن يأخذها من المرشحين، والورقة فئة الخمسين دولارًا المقطوعة نصفين والتي يأخذ الناخب نصفها مقدمًا ويأخذ النصف الآخر عند خروجه من قاعة الانتخابات لإثبات أنه انتخب الرجل الطيب المحسن المؤمن المطلوب منه انتخابه لا تصلح في أمريكا، فالدولار المقطوع لا مكان له في بلاد العم سام. ولأجل كل ما تقدم، يحترم الأمريكي نفسه وبلده ومرشحيه ويذهب بثقة إلى صندوق الانتخابات وهو يعلم أن صوته له تأثيره لا محالة، ولذا حاول الديمقراطيون أن يفتحوا أبواب أمريكا ومنافذها لدخول الغرباء، ومنهم مَنْ هم من المجرمين الهاربين من العدالة في بلادهم، وحاولوا منحهم حق الانتخاب والتصويت مثلهم في ذلك مثل المواطنين الأمريكان. ليس ذلك فقط، بل نجح الأمريكان في أن يقنعوا الجيل الجديد الذي أصبح الإنترنت إلهه، والفيس بوك كتابه، والإنستجرام والواتساب معبده، ولاعبي كرة السلة ملائكته، والمواقع الإباحية والجنسية شياطينه، ونجوم السينما والغناء أهله وإخوته، نجح الأمريكان بالرغم من كل هذا أن يخلقوا تقديرًا إيجابيًا خاصًا للعملية الانتخابية في أذهان هؤلاء الشباب، على الرغم أيضًا من أنهم ما زالوا شبابًا قد يندفعون لاختيار أحد المرشحين دون التدقيق أو الاطلاع على ماضيه وحاضره وبرنامجه أو برنامجها الانتخابي، ودون تفكير، إذا ما خسر مرشحهم الانتخابات -كما حدث مع كامالا- في الاندفاع بقوة إلى الشوارع في مسيرات واعتراضات، فهم لا يعلمون أن ما كُتب قد كُتب وأنه لا فائدة من كل ما يعملون. لكن الدروس الأساسية التي نتعلمها من هذه النقطة هي أننا نحتاج أن نتعلم أن الناخب الحر القادر على التعبير عن نفسه في حياته اليومية هو مَنْ لا تعوزه لقمة العيش ليأكل ولا المياه النظيفة ليشرب ولا ينقطع التيار الكهربي في بيته لساعات في حر الصيف وبرد الشتاء إلا في الكوارث الطبيعية، ولا يعامل كمواطن درجة ثانية بسبب ديانته أو إمكانياته المادية وغيرها، هذا الناخب هو وحده مَنْ يستطيع أن يعطى صوته لمن يعبِّر بصدق عنه وعن آماله وطموحاته، مهما كانت صفات المرشح. وهكذا يكون المرشح أيضًا على طبيعته، فإن كان سليط اللسان يبقى كما هو ولا يحاول أن يتجمل أو يداهن منتخبيه لكي يعطوه أصواتهم، فسلاطة اللسان، سواء ظهرت في وقت الانتخابات أو ظهرت بعد النجاح في الانتخابات، ستظهر لا محالة وعندها سيكتشف الناخبون أنهم أعطوا أصواتهم لممثل، شخصية غير حقيقية، يتلون ويتشكل وفقًا للظروف وليس لشخص أمين يترك نفسه على طبيعتها، وإن حاول التغيير يكون جادًا فيه، فيحدث التغيير في المرشح بغض النظر عن نجاحه أو فشله في القضية الانتخابية. فليس على المرشح تغيير تسريحة شعره أو نبرات صوته أو طريقة كلامه أو عصبيته أو هدوئه لكسب الانتخابات، فالناخبون الأمريكان من الذكاء حتى يعطوا أصواتهم لمن يكون على سجيته في كل المواقف والأزمات. ولعلنا كعرب عامةً وككنيسة خاصةً نحتاج أن نتعلم كيف نصنع من شبابنا العربي الذكي قوة محددة مهدفة موجهه لسير الانتخابات ونتائجها في بلادنا.